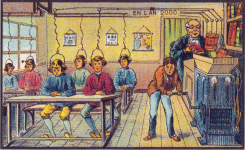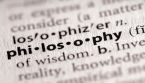هل الفلسفة في حاجة إلى ديداكتيك؟
كتب بواسطة: المحفوظ السملالي
يبدو للوهلة الأولى أن هذا السؤال متجاوزا بالنظر الى الحجج التي قدمها التيار المناصر لحضور الديداكتيكا في درس الفلسفة مدعوما بالمجهودات والتجارب التي راكمها الباحثين وأساتذة الفلسفة انطلاقا من التجارب الفصلية والاشتغال اليومي بقضايا الدرس الفلسفي مقتنعين تماما بضرورة خضوع الدرس الفلسفي إلى ديداكتيك يساعد على تقريب المعارف الفلسفية المجردة إلى أذهان المتعلمين،ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المادة ورهاناتها، باعتبار أن الفلسفة مادة مدرسية متفاعلة مع باقي المواد الأخرى متكاملة معها في التكوين الفكري والمنهجي والثقافي تسعى إلى تمرين التلاميذ على ممارسة التفكير النقدي الحر والمستقل والمسئول، ومساعدتهم على تشكيل النظرة التركيبة للمعارف والآراء التي يتلقونها، والتحرر من السذاجة الفكرية والعاطفية ومن الأحكام المسبقة والتعصب والعنف وسلبية التلقي والشجاعة في استخدام العقل ... إلا أن هذا الإشكال لم يحسم بعد بين كل الباحثين في مجال الفلسفة ومدرسيها، بل ظل يولد تيارين اثنين متصارعين احدهما يدعم الطرح الأول ويسعى إلى اعتماده والأخر يدعو إلى تقويضه وتبيان تهافته على اعتبار أن الفلسفة متفردة بمنهجها ومنطق اشتغالها عن باقي المواد الأخرى، فالفلسفة بما أنها كذلك، فهي تحمل في رحمها بداغوجيتها الخاصة وبالتالي فهي غنى عن أي ديداكتيك من شأنه أن يتحول إلى تقنية آلية يقتل حيوية الدرس الفلسفي.
إن هذا الحوار البيداغوجي لم يأتي من فراغ ولم يكن وليد اللحظة بقد رما هو استثمار وتطوير للأسس النظرية والمفهومية التي أبدعها المؤسسون الأوائل لفن البيداغوجية، خاصة بعد أن تحولت الفلسفة موضوعا للتدريس ( اللحظة الهيكلية والكانطية ) وهو الحوار عينه الذي لازال قائما إلى حدود اليوم، ولا يزال ينتج نفس التوجهات التي أنتجها مند لحظته الأولى، حيث أسس كانط لمنهجيته الخاصة في التدريس من خلال مقولة " إننا لا نعلم الفلسفة بقد رما نعلم التفلسف " أي تعليم التلميذ التفكير اعتمادا على ذاته، ويرى أن كل منج أو ديداكتيك يزعم انه سيتوصل إلى تلك الغاية على نحو آلي هو مجرد ادعاء ليس إلا، فلا أحد يستطيع أن يصنع فيلسوف أو ينتج موقفا فلسفيا مهما بلغت عبقريته البيداغوجية والديداكتيكية للآن التفلسف ليس آلة قابلة للتصنيع .
تعد مقولة سقراط الوجيزة "اعرف نفسك بنفسك" ذات العمق الدلالي البالغ الدقة والتعقيد في الوقت نفسه،من بين أهم المقولات التي تحدد بدقة متناهية الغاية من تدريس الفلسفة، إن المتأمل في هذه المقولة سيكتشف أنها تحمل بين طياتها عمقا بيداغوجيا رفيعا، يصرح بشكل ضمني أن فعل التفلسف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا مورس بشكل ذاتي، وقد عمل المشتغلون بحقل تدريس الفلسفة إلى صياغة هذا المبدأ على المستوى الديداكتيكي والمنهجي لقياس مدى نجاعة كل ممارسة تربوية هادفة في حقل تدريس الفلسفة .
إن تعلم التفلسف كما يقول" هيدغر" لن يتأتى إلا إذا أقدمنا على ممارسته بشكل ذاتي، أي إلا إذا حاولنا نحن أنفسنا أن نفكر، فتعلم التفكير كتعلم السباحة لا يغني أي درس فيها عن الارتماء في بركة الماء وخوض غمار السباحة .
ومن هنا نتساءل، هل هناك إمكانية لوضع ديداكتيكا للفلسفة متشبعة بالروح الفلسفية، تشيع روح التفكير والنقد لتوجيه ديداكتيك الدرس الفلسفي من الانزلاق في النزعة التقنوية التي من شأنها أن تحنط النصوص وتقضي على الروح الفلسفية النابضة فيها ؟
يوجد بين مدرسي الفلسفة اجماع على أن هدف تدريس الفلسفة هو تمكين التلاميذ من تعلم فكر حر وتأملي ونقدي ونظري، لا بشحنهم بمعرفة جاهزة [أطروحات ومواقف ] .
لقد عملت الباحثة الفرنسية "رولان فرانس" مند الثمانينات وبالضبط سنة 1982 حيث صدر كتابها " اليقظة الفلسفية" على تحقيق نوع من التوافق بين الفريقين المتنازعين حول منهجية تدريس الفلسفة، من خلال إقرارها بأهمية الديداكتيك دون تجاهل الجانب المعرفي المتعلق بضرورة تعليم الفلسفة من خلال تاريخها، للان إغفال الجانب المعرفي وعدم التمكن منه، يمكن أن يغتال الدرس الفلسفي ويفرغه من محتواه، لذلك لا بد من توفر الشرط المعرفي كدعامة أساس لكل تفلسف، ومن تم التفكير في الأدوات الكفيلة بتحويله إلى معرفة مدرسية تستجيب قدرات التلاميذ آخذة بعين الاعتبار مستواهم المعرفي والوجداني و العاطفي .
تم جاء عمل آخر لما يعرف بمجموعة "C.E.P.E.C" الخاصة ببداغوجيا الفلسفة، حيث تمت الإشارة إلى المذكرة الوزارية الصادرة سنة 1958 والتي جاء فيها مايلي :
" إن الفلسفة قادرة لوحدها أن تدافع عن نفسها، ولها بيداغوجيتها الخاصة بها،" معنى هذا أن الفلسفة ليست في حاجة إلى وسائط لتحقيق أهدافها، لكن تبين لمجموعة البحث هاته أن هذه المذكرة تبقى بعيدة عن الشروط الواقعية للتلاميذ , وقد عبروا عن عدم قدرتهم على استيعاب دروس الفلسفة، حيث أن التلميذ في الامتحان غير قادر على الإبداع بقد رما كان في إنشائه الفلسفي يكتفي باسترجاع ما تلقاه في الفصل، وكان يحصل على نقط متدنية تعيق مساره الدراسي، مما أدى إلى تكوين تصور سلبي عن مادة الفلسفة، وكانت هذه النتائج أفقا للبحث بالنسبة لهذه المجموعة، التي اعتبرت أن المسألة الديداكتيكية مسألة ملحة في الدرس الفلسفي، ما دام التلميذ مطالب بكتابة موضوع فلسفي يستجيب لمجموعة من المعايير ويجب أن يخضع لمنهجية محددة .
وخلصت مجموعة البحث إلى نتيجة مفادها أنه لايمكن أن نصير فلاسفة بمجرد الإنصات لخطابات ومدرسي الفلسفة، وبالتالي حصل الاتفاق على ضرورة "دكدكة الدرس الفلسفي أي إخضاع درس الفلسفة للديداكتيكا، كي لا نطلب مند التلميذ انجاز ما لم نعلمه انجازه بالطريقة التي تستجيب لمستواه المعرفي .
كما أن للأعمال مجموعة "تعلم التفلسف في ثانويات اليوم " بزعامة ميشيل طوزي آخرون الدور الريادي في حسم النقاش لصالح مسألة الديداكتيك، حيث تدعو المجموعة بقلم "فليب ميريو" إلى تجنب سوء تفاهم أول يتجلى في انه إذا كان تدريس الفلسفة يأخذ لنفسه كهدف للقاعدة الكانطية، التي تعتبر كل تلميذ يجرؤ على التفكير بنفسه ويستطيع التفلسف بدون وسيط بيداغوجي، أي أن أي طريقة ديداكتيكية وأي فهم بيداغوجي لا يستطيعان إكساب التلميذ بطريقة ميكانيكية القدرة على التفلسف، وبهذا المعنى تجعلنا عملية إدخال البيداغوجيا ضمن مجال الدرس الفلسفي في تناقض لايجد أساتذة الفلسفة أية وسيلة لدرئه، للان منع التلميذ من التفكير بنفسه وبشكل حر ومستقل أمر يتعارض مع البيداغوجيا نفسها، لكن لا أحد يستطيع تحرير المتعلم من أحكامه المسبقة ودفعه إلى استعمال التأمل العقلي بدون هذا الهاجس البيداغوجي، وبالتالي فلماذا التخوف من البيداغوجيا ؟ .
إن نفي البيداغوجيا، أو إقصاء الهاجس البيداغوجي، هو أطروحة بيداغوجية تظهر في الفلسفة كما في غيرها من المواد الأخرى، وذلك ضمن مناخ أو ممارسة بيداغوجية متميزة، إذ يتم التعلم فيها عن طريق الإعجاب بنموذج الأستاذ أو الفيلسوف [عبر عملية تهيئ سيكولوجي]، ومن هنا يمكن الحديث عن بيداغوجيا تعتمد الإلقاء، وإذا كان بعض الأساتذة يرون أن البيداغوجيا عديمة الفائدة في الدرس الفلسفي، بل تافهة ولا جدوى منها، فان البعض الأخر منهم يغرق "السوق" بكتيبات تجارية تنصح التلميذ وتوجهه نحو " إنتاج جيد" للامتحان الباكالوريا، ومع ذلك يحصل التلميذ على نتائج هزيلة أثناء عملية التقويم الإجمالي، للآن المقاييس والمعايير التي ينهجها التقويم لا زالت غير موحدة .
المراجع المعتمدة .
"تعلم التفلسف في ثانويات اليوم " لمشيل طوزي ومن معه ترجمة الدكتور حسن أحجيج، تقديم محمد سبيلا منشورات عالم التربية .
بحث لنيل الإجازة المهنية لمهن التدريس تخصص الفلسفة تحت عنوان،قراءة في كتاب "بناء القدرات والكفايات في الفلسفة " للباحث مشيل طوزي من انجاز الطالب المحفوظ السملالي السنة الجامعية 2015 ــ 2016
" مجلة نشرة التواصل الفلسفي "
التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي نونبر 2007
كتاب " اليقظة الفلسفية " لرولان فرانس.
أطروحة "ب. كوتينو" سنة 1988 حول " إلى أي حد وبأية لغة ينشغل مدرسوا الفلسفة بالبيداغوجيا في تدريسهم؟".
-
الزيارات: 1933